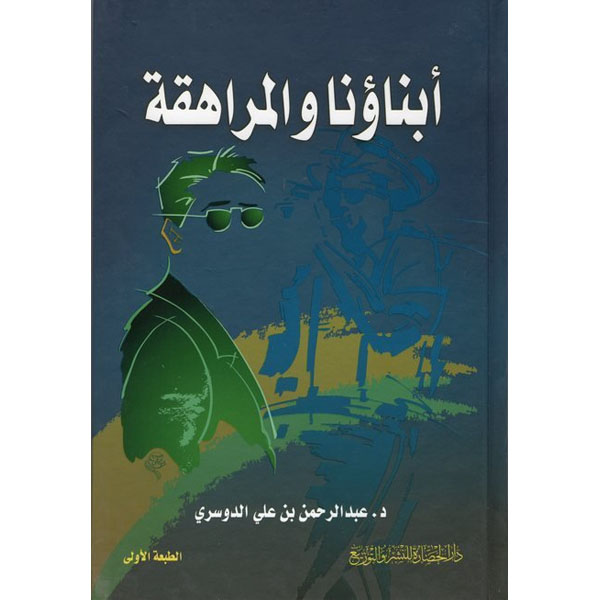انشروا الفرح
في كتاب «انشروا الفرح»، تقدم ساري كوندو دليلا مفصلا ومصورا حول كيفية التخلص من الفوضى وتنظيم أغراض سعددة ف النزل، بدءا من أغراض المطبخ والحمام وهولا إلى أوراق العل والمجمو عات الخامة بالهوايات. أسا الرسوم البسيطة فتصور طريقة كوندو في الطي،
ماذا نريد؟
هذا الكتاب يتوجه نحو إسقاط الضوء على المفاهيم الملتبسة لأهميتها وضرورة وضوح معانيها قدر المستطاع لما لها من أثر على الفرد والمجتمع .
معجم ميشيل فوكو
مهما كانت القيمة العليمة و الأكاديمية لهذا المعجم فإننا نعتقد أن القارئ العربي سيطلع على معجم جديد خاص بفيلسوف لا يزل يلقى اهتماماَ كبيرا في فكرنا وثقافتنا العربية المعاصرة .
سماء مقلوبة
ما الذي يربطني بهذا كله؟ ماضٍ سأتخلص منه حين أطل من نافذة الطائرةوهي تقلع نحو اللغة التي هربت إليها. شخوص أبعدتهك بيدي عن الحياة.واخرين سأبعدهم بحركة من رأسي. أنفض رأسي بشدة لتتساقط صورهموأيامهم من ارتفاع لا بأس به فوق سطح البحر. والدتي، سيخبرني فلاحأنها ماتت بعد رحيلي بعام أو أقل أو أكثر. لم يستدل لي على عنوان هناككي أحضر جنازتها. سأتظاهر بالحزن، وربما شكرته على رعايتها. بيت لمأتمتع به كما يجب. بيت من حجارة رملية وأعمدة خرسانية ورطوبةوسكون فاحش. حين أعود سابيعه وأغادر ” الجهراء”
الفلسفة واللغة
ليس هذا كتاباً في اللغة، ولا في فقه اللغة ولا في علم اللغة، وإنما هو كتاب في فلسفة اللغة، وفي مسألة من مسائلها الأساسية التي اصطلح عليها بـ”المنعطف اللغوي“
The linguistic turn.
فماذا يعني المنعطف اللغوي؟ وما هي المشكلة التي يطرحها في فلسفة اللغة؟ وما قيمته وأهميته في تاريخ الفلسفة المعاصرة؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة، هي التي تشكل موضوع هذا الكتاب.
كواليس- مفكرة شخصية
إنه ليس رواية، ولا قصة قصيرة أو كتاب فكري، وهذه ميزة كتاب الكواليس: هو يجمع أفضل ما في الرواية والكتاب الفكري والسيرة الذاتية، هو معرض فني، أو بصورة أوضح، هو متحف فني لتاريخ الآداب والفنون والأحداث التاريخية. كل صفحة من صفحات هذا الكتاب تحمل موضوعاً يخص شخصية معينة، تطرح في إطار معين وبأدوات محددة، وكل أداة من هذه الأدوات تم تقديمها بحرفية وفنية عالية؛ الرسم والخط والنص والفكرة، وهذه الأدوات اجتمعت مع بعضها البعض في إطار محدد، وانتجت متحفاً فنياً يحمل كل مقومات الآداب والفنون.
حتى الخلايا تقلق
اعتن جيداَ بالغصن الذي بداخلك
ذاك الذي يجف أحياناَ ويزهر..
من منا لا تتداوله الأيام؟
مخاض شجرة الرمان
هذه ليست رواية فحسب إنها تذكرة سفر إلى أقاصي إقليم خراسان حيث تتمخض الرمانة الخصبة في لحظة يقين لتلد المعجزات التي تلامس الروح الإنسانية وتتخطى توقعات العقل البشري
ها هي أصفهان العريقة رابضة بهدوء بين يديك هفل أزحت عن حسنها اللثام ؟